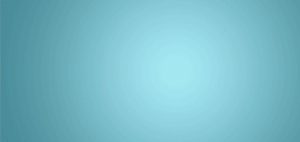لولا أعلم أني في الأثر
أحمد الفتلاوي
إعلامي من كربلاء المقدسة
/من قبل 1400 عام ونحن لازلنا نعيش مأساة كربلاء بكل أشكالها وتفاصيلها، عندما وقف الإمام الحسين(ع) أمام جيشٍ يفوقه بعشرات المرات؛ ثلاثة وسبعون رجلاً يقودهم سيدهم أمام أربعمائة من الطغاة الذين بايعوا الشيطان!
فكان ذلك الرجل وحده أمّة، فهو الحسين(ع) شهيد كربلاء ومن حوله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قضو جميعاً وما بدّلوا تبديلا، يتسابقون على الموت فرحين مستبشرين مؤمنين بوعدهم الصادق عقائديون تحسبهم ملائكة يكرون ولا يفرون، يتساقطون الشهيد تلو الشهيد، كُهُولِهم كالبرق وصبيانهم كالرعد، فيسقط كبير القراء ويعسوب قومه وشيخهم "مسلم بن عوسجة" فيدنو منه شيخ الأنصار "حبيب بن مظاهر" ليقول له: "يعز عليَّ مصرعك يا مسلم.. ابشر بالجنّة"، فقال له قولاً ضعيفاً: "بشَّرك الله بخير"، فقال له حبيب: "لولا أعلم إني في الأثر لأحببت أن توصي إليَّ بكل ما أهمك"، فماذا يوصي مسلم في حاله هذه؟
فما أعظمها من وصية وأشدّها وقعاً علينا نحن الموالون والعاشقون لسيد الشهداء(ع) ولكربلاء..
ستّون يوماً كل عام ونحن نحيي كربلاء الحسين(ع) ونتخذها شعاراً؛ ولكن قليلون منّا مَنْ يعيش تلك الواقعة بروحه وأحاسيسه، ومَنْ يريد أن يشهد جزءاً صغيراً من تلك الواقعة، مَنْ يريد أن يرى كربلاء المصغرة فهي تتجسد أمامنا الآن في غزة ولبنان.. فالظلامة هي ذات الظلامة والقوم أبناء القوم والقتل هو القتل ذاته والدماء هنا هي امتداد لتلك الدماء، أطفال يجزرون كأنهم الطير المذبوح ونساء تستباح وسبيٌ للحرائر، ليتفرد الأعداء بهولاء القلة، ويتفرج ويتخاذل الكثرة.. إنهم يستصرخون فلا يغاثون ويستنصرون فلا ينصرون، والشام هي الشام لم تتغير فلازالت الطبول تقرع فرحاً وتضرب الغانيات بالدفوف سروراً ورقصاً ويشمت أهل الحجاز وأراذل الكوفة من أيتام البعث وأبناء الرفيقات، ويعتقد مَن يعتقد بأن أهل الحق لا نجاة لهم؛ لكن عندما يعلو صوت الأذان انظروا لمن الغلبة ولمن البقاء، فمن لم يعِ كربلاء فها هي كربلاء كل يوم فينا وكل يوم عاشوراء وفي كل منعطفٍ ترى "شمراً" وقد ذبح الهدى فستأسدت إهواءُ..
فهل نحن متعضون؟ وهل نحن نتدبر الآيات ونعي الحقيقة ونخير أنفسنا بأيّ صفٍ نكون؟ أنكونَ مع الإمام الحسين(ع) وأصحابه أم مع يزيد وجيشه؟ أم نقف متفرجين ونكثر السواد على الحق وأهله ولا ندري، أفمدركون ومبصرون أن النصر آتٍ والفرج قريب «أَمْ حَسِبتُمْ أَنْ تَدْخُلُواْ الجَنَّةَ وَلَمَّا يَأتِكُمْ مَّثَلُ الذِينَ خَلَواْ مِنْ قَبلِكُمْ مَّسَّتهُمْ البَأَساءُ والضَّراءُ وَزُلزِلوا حَتى يَقُولَ الرَّسُولُ والَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصرَ اللهِ قَرِيِب» (البقرة/ ٢١٤).
ثمانون طنّاً من المتفجرات كانت كفيلة بنسف جبل راسخ من مكانه وتحويله دكّاً منسياً لقتل رجل واحد، فكان ذلك الرجل هو الجبل وأربعة آلاف رجل مدججين بالسيوف كانوا قادرين على هزم أمّة كبيرة شهروا سيوفهم بوجه الإمام الحسين(ع) وسبعون رجلاً من أصحابه، فكان الإمام الحسين(ع) أمّةً وحدهُ، من هنا نعرف عظمة المقتول وخسة ونذالة القاتل، إنها تشابه أدوار ووحدة هدف.
فذلك الرجل الذي ولد عام ١٩٦٤ في دير قانون النهر بلبنان ما انفك يوماً عن ملازمة ابن خالته الشهيد السعيد سيد شهداء المقاومة وسيد شهداء عصره السيد حسن نصر الله، قد أَلا على نفسه أن يكون رفيق دربه ليس في الدنيا فقط، وإنما في الآخرة أيضاً، وكأنه حبيب عصره الذي كان يعلم أنه في الأثر وإلا لَاَحب أن يوصيه ما أهمّه؛ ولكن يعلم أنه لاحق به لا محال، فما أسرع اللحوق وأطيب اللقاء في جنات عرضها السموات والأرض، تاركين مكانهم، رجال يستأسدون في أخذ الثأر أشداء على الكفار متفانين في القتال سيثبتون على الأهوال وأنهم راسخو الإيمان، كما قال قائد الثورة الاسلامية الإمام السيد
الخامنئي(دامت بركاته).
فنم قرير العين يا سيد هاشم واطمئن أبا رضا وأبلغ السلام عنّا لرفيق دربك أبا هادي السيد حسن نصر الله وسينبت الجنوب جنوداً يعشقون الموت كما الأعداء يعشقون الحياة وستثمر الضاحية رجالاً أشداء فيهم ألف حسن وألف هاشم وسترفع رايات النصر في القدس الشريف بيد الأبطال من أبناء المقاومة وستعلق صوركم أنتم يا سادة المقاومة ورايات حزب الله على بوابات فلسطين شاء مَنْ شاء، وأبى مَنْ أبى، وأن غداً لناظره لقريب.