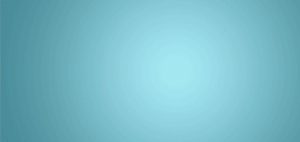الصفقة بين واشنطن وطهران..
تأثير محدود في ظل تعقيدات الواقع الأميركي
وسام اسماعيل
كاتب ومحلل سياسي
أظهرت المعطيات الأخيرة المتعلقة بالتجاذبات الإيرانية الأميركية تناقضاً أميركياً لناحية مصادفة توقيت إعلان اتفاق لتبادل السجناء بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية تعزيز قواتها في منطقة الخليج الفارسي وقرب مضيق هرمز، عبر إرسال عدة آلاف من الجنود، بالإضافة إلى قرارها إرسال عدد من طائرات F16 و F35 بحجة حماية التدفق الحر للتجارة الدولية في المنطقة. بطبيعة الحال، كان من الممكن تصنيف خبر إرسال القوات إلى الخليج الفارسي على أنه أمر عادي، بحيث إن الإدارة الأميركية، بقيادة بايدن، أعلنت أن الهدف الأميركي في العلاقة بإيران لن يخرج عن القرار الاستراتيجي القاضي باحتوائها، وبحيث إن الإدارة الحالية العاجزة عن تقديم ضمانات تساعد على العودة إلى اتفاقية العمل المشتركة الشاملة لعام 2015، والضامنة عدم وصول إيران إلى عتبة القدرة على امتلاك تقنية إنتاج سلاح نووي، بالإضافة إلى الفشل في ربط قدرات إيران الصاروخية وعلاقاتها الإقليمية بمندرجات القرار 2231، من الطبيعي أن تحاول تقديم نفسها ضابطاً لإيقاع العلاقات الإيرانية الأميركية، ومتحكماً في مساراتها من خلال إظهار قدرتها على إدارة استراتيجيات التهديد، عبر الإيحاء في قدرتها على إعادة حشد قواتها في الخليج الفارسي، تحت عناوين قديمة متجددة تتعلق بأمن الملاحة والعبور.
وعليه، فإن خبر الحديث عن صفقة، ظهر منها إلى العلن ملف الإفراج عن سجناء أميركيين في مقابل تحرير أموال إيرانية في الخارج، لن يكون عادياً في هذا السياق، وخصوصاً إذا تمت مقاربته في إطار مواقف الإدارة الأميركية الأخيرة المتصلبة تجاه التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط، بحيث إن أي حل لقضايا الإقليم لن تكون مقبولة إلا إذا تم تسييلها ضمن إطار توازن دولي ملائم لمصالحها، وهذا ما لم تنضج مفاعيله حتى هذه اللحظة. وعليه، يفترض تحليل الأهداف الأميركية من هذا السلوك المتناقض، ومحاولة إيجاد المساحة المشتركة التي قد تكون دافعاً وراء انفتاح الجمهورية الإسلامية على صفقات كهذه.
إذن، كان من الممكن تحليل المنطق الإيراني، الداعي إلى التوصل إلى صفقة كهذه، بحيث إن براغماتية الحكومة الإيرانية ظهرت من خلال عدم تحول حَزمها بشأن المحافظة على أمنها في منطقة الخليج الفارسي وعدم ترددها في احتجاز سفن التهريب، وقرارها النهائي بشأن المحافظة على علاقاتها الاستراتيجية بروسيا، على رغم اتهامها بمساعدة روسيا عسكرياً وفرض عقوبات عليها، إلى عائق يهدد مسعاها للعودة إلى خطة العمل المشتركة لعام 2015، أو نجاحها في التوصل إلى اتفاق على إعادة العلاقات بالمملكة العربية السعودية. من هذا المنطلق، يمكن تقويم السلوك الإيراني على أنه متحرك في إطار البحث عن مصالحها ضمن منطلقات الأمن القومي والسيادة. لذلك، فإن ما ظهر في الصفقة الأخيرة، حيث وافقت إيران على الإفراج عن عدد من السجناء مقابل تحرير أموالها من البنوك الكورية الجنوبية والعراقية، يؤكد واقعية متخذ القرار الإيراني، الذي استطاع أن يُلزم الولايات المتحدة الأميركية بتحقيق شرط من أهم الشروط التي طرحها مدخلاً للعودة إلى خطة العمل المشتركة، من دون أن يقدم أيّ تنازل، بحيث إنه لم يتم الحديث عن أي تخفيض في نسبة التخصيب، أو عن سلوك إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي.
لذلك، تظهر إشكالية هذه الصفقة عند تحليل المنطق الأميركي المبرّر لها في لحظة اتخاذ وزارة الحرب الأميركية قرارها حشد قوات استراتيجية إضافية في منطقة الخليج الفارسي، تحت ذريعة مواجهة إيران. فالإدارة الأميركية، المنغمسة في حرب كونية لحفظ ما تبقّى من موقعها في رأس النظام العالمي، والغارقة في مواجهة المعارضة الداخلية الباحثة عما يساعد على عودتها إلى الحكم عبر الانتخابات الرئاسية المقبلة، تبحث عمّا يمكن أن تستجمعه من أدوات القوة القادرة على تحقيق أهداف استراتيجيتها للأمن القومي الأخيرة، والتي أعلنها بايدن نهاية العام الماضي. فالتركيز على كيفية مواجهة القوى الكبرى، القادرة على تغيير موازين القوى العالمية، كالصين وروسيا، يفترض ابتداع حلول في الملفات والقضايا التي قد تصبح هامشية مقارنةً بذلك الهدف. بالإضافة إلى ذلك، قد يُظهر الضعف الأميركي، وعدم القدرة على التحكم في مسار الأزمات الكبرى، ميلاً نحو محاولة البحث عن نجاحات يمكن تسويقها على أنها دليل على عدم فقدان القدرة على المبادرة أو التحرك.
وإذا راجعنا الأحداث الأخيرة، التي أثّرت سلباً في موقع الولايات المتحدة عالمياً وإقليمياً، فإن محاولة حصرها في عدد أصابع اليد لن تكون أمراً ممكناً، انطلاقاً من أوكرانيا والتململ الأوروبي من إطالة أمد الحرب، وصولاً إلى الدور الصيني المتعاظم، مروراً بفشل سياسة العقوبات الأحادية والتخلي العالمي عن الدولار في التجارة العالمية، وخروج بعض القوى الإقليمية، كالمملكة العربية السعودية، عن الطاعة الأميركية، بالإضافة إلى الأزمة التي تعصف بالعلاقة بالكيان الإسرائيلي، وضعف جبهة الكيان الداخلية، وانقساماتها وفشل مشاريعها في اليمن وسوريا والعراق، من دون أن ننسى لبنان.
لذلك، يمكن القول إن محدودية الصفقة الأخيرة بين الطرفين الأميركي والإيراني لا تصلح لتأسيس مرحلة من الانفراج في العلاقات بين الطرفين، بحيث إن الإرادة الأميركية بشأن التوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين ما زالت مفقودة. وإذا كان واضحاً مدى إشادة الجانبين بالجهود التي أدّت إلى حدوث الصفقة، ومحاولة تظهيرها على أنها مدخل يمكن الركون إليه في المرحلة المقبلة، فإن الرغبة الإيرانية في التوصل إلى رفع العقوبات، مقابل اتفاق نووي عادل، لا يلاقيها سعي أميركي واضح وحقيقي نحو حل أزمة العلاقة بالجمهورية الإسلامية. فالإدارة الأميركية الحالية، والتي تستعد لحملة تجديد انتخاب الرئيس بايدن، لن تدخل في اتفاق تعلم بأنه لا يمكن ضمان عدم استغلاله من جانب الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى عدم قدرة بايدن على إقناع اللوبي الإسرائيلي، المتمترس خلف مواقف اليمين المتطرف الصهيوني، الذي يرى تأثيراً سلبياً لأي اتفاق أميركي إيراني في أمن الكيان.
وعليه، يمكن القول إن ما يمكن أن يتحقق، في هذه المرحلة، من انفراجات محدودة في العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية سيصطدم بغياب الظروف الإقليمية والدولية الملائمة لتسييله في إطار اتفاق شامل بين الطرفين. فالفشل الأميركي في تطويع الجمهورية الإسلامية في برنامجها النووي، منذ حاول الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون الضغط على إيران من خلال فرض حظر عليها، بالإضافة إلى الواقع الأميركي المتأزم دولياً، والمنهمك بمعركة الرئاسة المقبلة، لا يمكن أن يقدّم إلى الإدارة الحالية ظروفاً ملائمة لتسويق اتفاق شامل مع الجمهورية الإسلامية في الوقت الحالي.