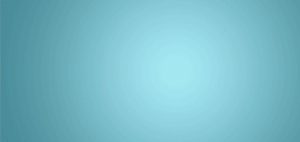حول إنحطاط العقل السياسي..
ما هو «الترورامبيسم»؟ (1/2)
د. محمد أخكري
عضو هيئة التدريس في جامعة الإذاعة والتلفزيون
«الترورامبيسم» أو «الإرهاب الترامبي» في هذا المقال لا تُدرَس بوصفها اسمًا لشخص أو لمرحلة زمنية، بل بوصفها حالة عقلانية–سياسية؛ حالةٌ يتحوّل فيها الإرهاب من فعل إستثنائي إلى منطق مُنظِّم. بالاعتماد إلى التقليد الكانطي في نقد العقل، والاستفادة من التحليل النقدي للخطاب، يُبيَّن كيف أن العقل واللغة والقانون والذاكرة والأخلاق والراوي والرواية تُضعَّف أو تُدمَّر بصورة منهجية داخل هذه الحالة. ويُجادل الكاتب بأنّ الترورامبيسم هي الصياغة المعاصرة للاستعمار ما بعد الحداثي: سياسة لا تسعى للهيمنة ليس فقط على الأرض، بل أيضاً على إمكانية الحكم العقلاني ذاته. وتبرز الخلاصة، بالعودة إلى سؤال كانط «جرأة الحكم»، ضرورة إعادة بناء العقلانية السياسية.
هذا المقال ليس تأريخًا لدولة ولا تحليلًا نفسيًا لسياسي. إنّ قضيته هي صياغة الشروط التي تتكلّم فيها السياسةُ بلغة العقل؛ لكنها لم تعُد تعتبر نفسها مُلزَمة بالمساءلة أمام العقل.
ما يُسمّى في هذا المقال «الإرهاب الترامبي» هو اسم لبُنية. بُنية يتحوّل فيها العنف والإقصاء والارهاب إلى مبادئ لممارسة السياسة. في الأفق الكانطي، لا تكون السياسة مشروعة إلّا حين تستطيع الصمود أمام حكم العقل العام. وكلّما أعفت السلطةُ نفسها من هذا الحكم، انحدر العقل من مقام التشريع إلى مجرّد أداة للتبرير.
«الإرهاب الترامبي» هو اسم لحالة يهبط فيها العقل من مقام الحكم، وتتحوّل اللغة فيها من وسيط للفهم إلى أداة لإثارة الهلع. فإذا كانت الأنوار، بتعبير كانط، خروج الإنسان من قصوره الذي ارتضاه لنفسه، فإنّ «الإرهاب الترامبي» يجب اعتباره عودة واعية إلى ذلك القصور؛ ليس بسبب العجز عن التفكير، بل بسبب تفضيل الطاعة، والانفعال، والأمن الوهمي على الحكم العقلاني.
بهذا المعنى، ليس «الإرهاب الترامبي» مجرد اسم لتيار سياسي، ولا یقتصر على شخص أو فترة بعينها، بل هو علامة على تحوّل في لغة السياسة؛ تحوّل يصبح فيه التهديد بديلاً عن الاستدلال، والهلع بديلاً عن الإقناع.
في هذا النظام الفكري، لم يعُد الإرهاب حدثًا إستثنائيًا، بل قاعدة غير مكتوبة تحكم علاقات السلطة. الإرهاب ليس قتل الأجساد فحسب، بل قتل المعنى، والقانون، والمسؤولية. «الإرهاب الترامبي» يبدأ من اللحظة التي يصبح فيها العنف، بدلًا من أن يكون آخر الحلول، الأداة الأولى؛ وتختار فيها السياسة لغة الأمر والتهديد بدلًا من الحوار. في هذه الحالة، لا يكون القانون معيارًا عامًا، بل أداة مرنة في يد السلطة؛ مُلزِمًا للآخرين، ومعلّقًا بالنسبة للسلطة نفسها. وهكذا تُفرَّغ الحقوق من حقيقتها، وتُختزل إلى لغة شكلية.
هذا المنطق، رغم أنه أصبح أكثر وضوحاً في العصر الحديث باسم ترامب، إلّا أنّ يجب البحث عن جذورها في القرن الأمني الجديد؛ حينما أُعيد تصوير العالم بعد 11 سبتمبر ليس بوصفه مجموعة من الذوات القانونية، بل كحقل معركة دائم. تقسيم العالم إلى خير وشر، حضارة وهمجية، وصديق وعدو، كان الخطوة الأولى لتعليق العقل النقدي. ومنذ ذلك الحين، أصبح كل فعل يندرج ضمن هذا الإطار الثنائي مشروعًا مسبقاً، دون الحاجة إلى أيّ تقييم أخلاقي أو قانوني.
في هذا المسار، ابتعد العنف عن صورته العارية وأصبح تدريجيًا مُؤسسًا. ما كان يُسمّى يومًا «إستثناءً» تحوّل إلى «إجراء» ثابت. الإرهاب الموجَّه، العقوبات الجماعية والإقصاء الجسدي دون محاكمة، جميعها قُدِّمت في هيئة عقلانية أمنية. وهكذا تَشكّلت سياسة يمكن تسميتها بـ«الإرهاب القانوني»: عنفٌ يُمارَس ليس في الخفاء، بل في وضح القانون المُفسَّر لصالح السلطة.
عهد ترامب كان ذروة وعرض هذا المنطق. ما كان يُخفى سابقًا أو يُغلَّف بلغة دبلوماسية، بات يُقدَّم الآن عاريًا بلا ستار. التهديد أصبح علنيًا؛ والإهانة مفخرة؛ والإرهاب إعلانًا رسميًا. هنا خرج «الإرهاب الترامبي» تمامًا من كونه ميلاً أو أسلوبًا، واتخذ شكل عقيدة: عقيدة ممارسة السياسة عبر الهلع.
من الخطأ الاعتقاد بأنّ هذا المنطق يزول بتغيّر الأشخاص. استمرار السياسات نفسها بلغة أكثر ليونة أظهر أنّ «الإرهاب الترامبي» ليس مرتبط بالإرادة الفردية بقدر ما هو متجذّر في بُنية السلطة. إنّ الارتباط بين اقتصاد الحرب، والتفسير الأداتي للقانون الدولي، والتمثيل العِرقي للعدو، يُشكّل أساس هذه البُنية.
ومن هنا، يمكن تلخيص «الإرهاب الترامبي» على النحو الآتي: نظام سياسي يُختزل فيه العقل إلى أمن، والأخلاق إلى مصلحة، والقانون إلى أداة. نظام يُفرغ اللغة من الحقيقة ليجعل العنف يبدو طبيعيًا.
نهاية «الإرهاب الترامبي» لا تتحقق عبر تبدّل مواقع السلطة، بل عبر إعادة بناء العقلانية السياسية؛ عبر العودة إلى ذلك المبدأ البسيط لكنه المنسيّ، وهو أنّ السياسة دون مساءلة عقلانية وأخلاقية ليست سوى إدارة للخوف. فإذا كان التنوير دعوةً إلى «جرأة التفكير»، فإنّ نقد «الإرهاب الترامبي» هو دعوة إلى جرأة المقاومة في مواجهة الهلع؛ ذلك الهلع الذي يُسمّي نفسه عقلًا؛ لكنه في الحقيقة نفي للعقل.
وجوه مختلفة لـ«الإرهاب الترامبي»:
1. إرهاب العقل
أوّل ضحايا «الإرهاب الترامبي» هو العقل؛ ليس العقل بوصفه حسابًا، بل العقل بوصفه مصدراً للحكم. القرار السياسي لم يعُد نتيجة تقييم عام، بل يُقدَّم بوصفه بداهةً أو ضرورةً أو حالة طوارئ. العقل يصبح لاحقًا: مهمّته تبرير قرار اتخذ مسبقاً. في لغة كانط، هذه الحالة هي اغتراب العقل؛ إذ بدلًا من أن يستمدّ قانونه من ذاته، يخضع لإرادة خارجية تُسمّي نفسها أمنًا أو واقعيةً أو مصلحة.
يُغتال العقل حين لا يعود مشرّعًا لذاته، وحين يسلّم حكمه لإرادةٍ خارجية تظهر غالبًا في صورة «الأنا». هنا، الأنانية ليست مجرد صفة نفسية، بل تصبح مبدأً ميتافيزيقيًا: «الأنا» تعتبر نفسها معيار الحقيقة، وتجبر العقل على الطاعة بدلاً عن الحكم. هكذا يسقط العقل من مقام القاضي المحايد إلى محامي دفاع مهمّته ليست التمييز بين الحق والباطل، بل تبرئة الإرادة الذاتية مسبقًا.
في هذه الحالة، لا يكون القصور ناتجًا عن عجزٍ في الفهم، بل نتيجة الامتناع الإرادي عن الحكام. الإنسان، بدلًا من امتلاك شجاعة استخدام عقله، يختار راحة الطاعة لـ«أنا القوي». وهذا هو القصور الذي يسمّيه كانط «القصور الإرادي»: حيث يمتلك العقل القدرة على الحكم؛ لكنه فقد جرأة ممارسته. الأنانية، بوعد الأمن أو العظمة أو الهُويّة، تدفع العقل إلى الانسحاب؛ وفي هذا الانسحاب يتحقق إرهاب العقل بصمت.
في «الإرهاب الترامبي»، تصبح هذه الأنانية المبدأ المنظّم للسياسة وتحل محل العقل الجمعي. يُعلَّق الحكم العقلاني، الذي هو شرط إمكان الكونية، مسبقًا؛ لأنّ كلّ حكم يُقاس ليس بقدرته على التعميم، بل بمدى توافقه مع «الأنا». سؤال كانط: «هل يمكن أن نرغب في أن يصبح هذا الحكم قانونًا كونيًا؟» يُستبدل بسؤال أدنى: «هل يعزز هذا الحكم قوّتي وصورتي؟» وهكذا تُستبدل استقلالية العقل باستبداد الأنانية، وتسقط السياسة من مجال التنوير إلى ساحة الإرادة المنفلتة.
إرهاب العقل، بهذا المعنى، هو النقيض المباشر للخروج من القصور. فبدلًا من أن يتحرر الإنسان من وصاية الآخر، يُسلِّم نفسه لوصاية «الأنا» التي لا تخضع للمساءلة ولا يمكن الحكم عليها. العقل، الذي يجب أن يكون شرط إمكان الحرّية، يُختزل إلى أداة لترسيخ الأنانية. وهكذا، فإنّ «الإرهاب الترامبي» ليس مجرد عنف سياسي، بل انهيارًا أخلاقيًا للتنوير: اللحظة التي يتخلّى فيها الإنسان، عن وعي، عن حقّه في الحكم، ويجعل العقل قربانًا لعظمةٍ متخيَّلة لـ«الأنا».
2. إرهاب اللغة
اللغة هي شرط إمكان العقل؛ لكن في «الإرهاب الترامبي» تتحوّل اللغة من أداة للفهم إلى أداة للتحريض. تُستعمل الكلمات ليس للتوضيح، بل لإثارة الهلع والغضب والولاء. يحلّ الأداء محلّ الصدق. ويُظهر التحليل النقدي للخطاب أنّ اللغة، في هذا الوضع، لا تمثّل الواقع بل تُنتجه. وهكذا يُغلق إمكان الحوار العقلاني مسبقًا. فقبل أن يصل العنف إلى الشارع، وقبل أن تُقلِع طائرةٌ مسيّرة أو تُفرض عقوبة، تكون كلمة قد تغيّرت، ومعنى قد أُفرغ، وعلاقة أساسية بين اللغة والحقيقة قد انهارت.
ما ظهر في عهد ترامب لم يكن مجرّد أزمة سياسية؛ بل كان علامة على خراب بيت اللغة، ذلك البيت الذي لم تعُد الحقيقة تسكنه. في التقليد الكلاسيكي، اللغة وسيط للمعنى؛ جسر بين الذوات، ومرآة لانكشاف الحقيقة. الكلمات يُفترض أن تُفهِم، لا أن تُخيف؛ أن توضح، لا أن تُقصي؛ لكن في الخطاب الترورامبي، تسقط اللغة من مقام الوساطة إلى أداة للهيمنة. لم تعد الكلمات تُستخدم لاكتشاف الحقيقة، بل لصنع «حقيقة بديلة»؛ حقيقة لا تولد من حكم عقلاني، بل من التكرار والشدة والتحفيز. في هذا النظام اللغوي، الحقيقة ليست ما يُكتشَف، بل ما يُفرَض.
مصطلح مثل «أخبار كاذبة» ليست مجرّد ملصق؛ بل فعل تدميري. ما يُستهدَف ليس تقريرًا بعينه، بل الثقة العامة في إمكانية وجود حقيقة مشتركة: الإعلام، الجامعة، المؤسسة القانونية. وهكذا تتحوّل اللغة من وسيط للمعنى إلى سلاح أيديولوجي. وكما حذّر بودريار، لم تعُد العلامات تُمثّل الواقع؛ بل حلّت محلّه. نحن أمام عالمٍ لا تصف فيه اللغة الواقع، بل تشغل مكانه.
في هذا الأفق، لا تصبح شبكات التواصل أدوات تواصل، بل ساحات للحكم اللغوي. المنشور أو التغريدة لم تعد تقريرًا عن حدث، بل فعلًا في جبهة اللغة. كل جملة هجوم على معنى، وكل كلمة حاملة لرسالة قتالية. لغة ترامب بسيطة؛ لكنها ليست الفهم، بل لتعطيل التفكير. الكلمات ليست حاملة لمفهوم، بل لعاطفة: خوف، غضب، ازدراء. هذه اللغة لا تبني جسرًا؛ بل تشيّد جدارًا. تضع «نحن» في مواجهة «هم»، ومع كل تكرار، يرتفع هذا الجدار أكثر.
من منظور نظرية الفعل الكلامي، لا تكتفي اللغة بوصف الواقع، بل تصنعه. في «الإرهاب الترامبي»، تبلغ هذه السمة الفاعلة للغة ذروتها. الكلمات تُصدر أحكامًا، وتخلق أعداء، وتُشرعن العنف مسبقًا. عندما يُسمّى الإعلام «عدوّ الشعب»، تتحوّل لغة النقد إلى تهديد وجودي. وهكذا تُضعَّف قدرة الحكم العام، ويُفقد العقل الجمعي اعتباره قبل أن يُقمع فعليًا.
في هذا الخطاب، تلعب التراكيب اللغوية التي تبدو متناقضة -مثل إعلان «الإبادة الكاملة» ثم مباشرة «الآن وقت السلام»- دورًا بنيويًا. فالعنف لا يُعرض العنف في مقابل السلام، بل يُقدم كشرط لإمكانه. اللغة، هنا لم تعد مرآة للحقيقة؛ بل أصبحت مطرقة للهيمنة. الكلمات لا تعبر عما هو كائن، بل تفرض ما يجب قبوله.
أحد الآليات المحورية في هذا الإرهاب اللغوي هو صناعة عدوّ مطلق. فـ«العدو» في هذا الخطاب ليس مخالفًا، بل كيانًا مُهدِّدًا يجب إزالته. الإعلام، المهاجر، الجامعة أو الدولة المنافسة، جميعها تُعاد صياغتها في صورة واحدة: عقبة، فاسدة، خطيرة. اللغة، عبر حذف السياقات التاريخية وتعقيدات السياسة، تختزل العالم إلى قطبين بسيطين. في مثل هذا المناخ، يصبح الحوار مستحيلًا؛ لأن اللغة تكون قد أقصت الآخر مسبقًا من دائرة الإنسان القابل للخطاب.
لغة الإهانة والوصم هي الركن الآخر لهذا النظام الخطابي. الإهانة هنا ليست مجرد إساءة شخصية؛ بل هي إرهاب للشخصية. الآخر لا يُنتقد ولا يُرفض؛ بل يُختزَل. وهذا الاختزال هو شرط إمكان العنف اللاحق، لأن مَن يُجرَّد من منزلته يصبح قابلًا للإزالة. وكما أظهر محلّلو الخطاب، فإنّ الإهانة اللغوية هي الأرضية المسبقة للهيمنة المؤسسية والعسكرية.
في النهاية، تعمل اللغة الترورامبيّة عبر التبسيط المفرط والثنائية المطلقة. تُختزل القضايا المعقّدة إلى خيارات غريزية: إمّا معنا أو ضدّنا. يُمحى الطيف الرمادي، وتتحوّل المؤسسات التحليلية - الجامعة، المحكمة والعلم - إلى عائق أو عدو. تخرج اللغة من مجال التفكير وتدخل مجال الأمر. ما يهم ليس الصدق، بل الملاءمة؛ وليس الحقيقة، بل الولاء.
إذا اعتبرنا اللغة، بتعبير هايدغر، بيت الوجود، فإنّ «الإرهاب الترامبي»، تبني لغةً يكون فيها العنف ليس ضيفًا، بل ساكنًا دائمًا. في هذا البيت، الحوار يُستبدل بالصراخ. العنف يحدث في اللغة قبل أن يظهر في الشارع. وعندما تنهار اللغة، ينهار المعنى معها؛ تُخرس الفلسفة، وتتكلم الدعاية بدلًا منها.
لهذا، «الإرهاب الترامبي» قبل أن يكون سياسة أمنية، هو مشروع لغوي. وإذا كان ثمة سبيل لمقاومته، فإنّه يبدأ بإعادة بناء ما تهدّم أولًا: اللغة العامة؛ لغة الحوار، لغة الحكم ولغة العقل.
يُتبع...