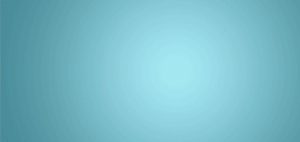صوت واحد أربك المنظومة العالمية
ألبانيزي في قلب العاصفة.. حين تصطدم الحقيقة بجدار النفاق الغربي
/ في لحظات تاريخية معيّنة، لا يعود الصراع مجرّد مواجهة بين دول وجيوش، بل يتحوّل إلى مواجهة بين كلمة وحصار، بين ضمير فرد ومنظومة كاملة من المصالح والهيمنة. هذا بالضبط ما يجري اليوم مع المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، التي وجدت نفسها في قلب عاصفة سياسية وإعلامية غربية، فقط لأنها قررت أن تسمّي الأشياء بأسمائها، وأن تصف ما يحدث في غزّة بأنه إبادة، وأن تشير إلى أن المشكلة ليست فقط في الاحتلال، بل في النظام الدولي الذي يحميه ويمنع محاسبته.
الهجوم الفرنسي والألماني على ألبانيزي ليس حادثًا عابرًا، ولا مجرّد اختلاف في التقدير السياسي، بل هو نموذج مكثّف لطريقة عمل المنظومة الغربية حين تشعر أن أحدًا يهدّد احتكارها للرواية، أو يجرؤ على فضح تناقضاتها. فبدل أن تُناقش تقاريرها، أو تُفند معطياتها، أو تُواجه حججها بحجج مضادة، اختارت باريس وبرلين الطريق الأسهل والأخطر: شيطنة الشخص بدل مناقشة الفعل، واستهداف المقرّرة بدل مواجهة الحقيقة التي تحملها.
كيف تحوّلت جملة إلى تهديد استراتيجي؟
ما قالته ألبانيزي في جوهره لم يكن جديدًا على مستوى المضمون، لكنه كان صادمًا على مستوى المنبر والتوقيت والوضوح. فهي لم تتحدث كناشطة مستقلة أو ككاتبة رأي، بل بصفتها مقرّرة خاصة للأمم المتحدة، أي بصفتها جزءًا من منظومة دولية يفترض أنها محكومة بالتوازنات والضغوط والتسويات. ومع ذلك، اختارت أن تتحدث بلغة أقرب إلى لغة الضمير الحرّ منها إلى لغة الدبلوماسية الباردة، وأن تصف ما يجري في غزّة بوصفه إبادة، وأن تشير إلى أن العدو المشترك للبشرية ليس كيان الاحتلال ككيان مجرد، بل النظام الذي يمنع محاسبتها، ويمنحها حصانة سياسية وقانونية وعسكرية.
هذه النقطة تحديدًا هي التي فجّرت الغضب الغربي. فحين تقول ألبانيزي إن المنظومة التي تحمي الاحتلال هي العدو المشترك للبشرية، فهي لا تتهم الاحتلال وحده، بل تضع في قفص الاتهام دولًا كبرى، وحكومات نافذة، وشبكات مصالح اقتصادية وعسكرية وإعلامية. هي لا تتحدث عن جريمة معزولة، بل عن بُنية كاملة من التواطؤ، تمتد من مصانع السلاح إلى غرف الأخبار، ومن قاعات البرلمانات إلى غرف الضغط المغلقة، ومن الخوارزميات التي تتحكم في تدفق المعلومات إلى المنابر التي تصنع الرأي العام.
من هنا يمكن فهم حدّة رد الفعل الفرنسي والألماني. فوزير الخارجية الفرنسي لم يكتفِ بوصف تصريحاتها بأنها «شائنة»، بل حاول أن يقدّمها للرأي العام على أنها تستهدف «الشعب الصهيوني» لا الحكومة أو النظام، في محاولة واضحة لتحويل النقاش من مستوى القانون الدولي إلى مستوى الاتهامات الأخلاقية والشخصية. أمّا وزير الخارجية الألماني، فذهب أبعد من ذلك حين قال إنها لا يمكنها الاستمرار في منصبها، وكأن وظيفة المقرّر الأُممي هي أن يلتزم بالسردية الغربية، لا أن يلتزم بالوقائع التي يراها على الأرض.
بهذا المعنى، لم يكن الهجوم على ألبانيزي ردًا على تقرير أو تصريح، بل كان محاولة استباقية لإرسال رسالة إلى كل من يفكر داخل المنظومة الأممية أو الحقوقية في أن يرفع سقف كلامه: هناك حدود غير مكتوبة لما يمكن قوله، ومن يتجاوزها سيدفع الثمن.
ازدواجية المعايير.. حين يتحوّل القانون إلى أداة انتقائية
الهجوم على ألبانيزي يكشف بوضوح ما يعرفه كثيرون منذ زمن، لكن الغرب كان ينجح غالبًا في تغليفه بخطاب ناعم: القانون الدولي في الممارسة الغربية ليس منظومة مبادئ ثابتة، بل أداة انتقائية تُستخدم ضد الخصوم وتُعطّل حين يتعلق الأمر بالحلفاء. في حالات معينة، تُستدعى مفردات مثل «جرائم حرب» و«مسؤولية الحماية» و«التدخل الإنساني» بسرعة مذهلة، كما حدث في أكثر من ساحة حول العالم. لكن حين يكون الفاعل هو كيان الاحتلال يتغيّر القاموس فجأة، وتصبح الكلمات أكثر حذرًا، والبيانات أكثر غموضًا، والقرارات أكثر بطئًا، والقتل أكثر قابلية للتبرير.
في هذا السياق، يصبح من المفهوم لماذا اختارت باريس وبرلين أن تهاجما ألبانيزي بدل أن تناقشا مضمون تقاريرها. فمجرد الاعتراف بأن ما يجري في غزّة قد يرقى إلى مستوى الإبادة يعني فتح الباب أمام أسئلة خطيرة: ماذا عن الدول التي زوّدت الاحتلال بالسلاح في هذه الحرب؟ ماذا عن الحكومات التي منعت صدور قرارات ملزمة في مجلس الأمن؟ ماذا عن العواصم التي استقبلت قادة الاحتلال بينما كانت طائراتهم تقصف المدنيين؟
هذه الأسئلة لا تُهدّد كيان الاحتلال وحده، بل تهدّد شرعية منظومة كاملة من العلاقات والتحالفات. ولذلك، فإن أسهل طريقة للتعامل معها هي منعها من أن تُطرح أصلًا، عبر ضرب من يجرؤ على طرحها. هنا تحديدًا يمكن فهم محاولة البرلمان الفرنسي تجريد ألبانيزي من تفويضها بتهمة «معاداة السامية»، وهي تهمة تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى سلاح جاهز يُشهر في وجه كل من ينتقد كيان الاحتلال بجدية، حتى لو كان نقده يستند إلى القانون الدولي وإلى تقارير موثّقة.
لكن المفارقة أن هذه المحاولة اصطدمت برد فعل قانوني داخل فرنسا نفسها، إذ أعلنت جمعية محامين فرنسيين نيتها مقاضاة النواب الذين حرّفوا تصريحات ألبانيزي. هذا التطور يكشف أن المعركة لم تعُد فقط بين ألبانيزي وحكومات غربية، بل بين رؤيتين داخل الغرب ذاته: رؤية تريد أن تبقي كيان الاحتلال فوق المساءلة، ورؤية أخرى بدأت تدرك أن استمرار هذا الاستثناء يدمّر ما تبقّى من مصداقية الخطاب الغربي عن حقوق الإنسان.
ألبانيزي كرمز.. من وظيفة أُممية
إلى حالة عالمية
ما حدث مع ألبانيزي جعلها تتجاوز موقعها الرسمي لتتحوّل إلى رمز. لم تعُد مجرد مقرّرة خاصة تكتب تقارير دورية، بل صارت في نظر كثيرين تجسيدًا لصراع أوسع بين من يريد أن يعيد الاعتبار لفكرة العدالة الدولية، ومن يريد أن يبقيها خاضعة لموازين القوة. هذا التحوّل لم يأتِ من فراغ، بل من تلاقي عاملين أساسيين: من جهة، وحشية ما يجري في غزّة، التي لم يعُد ممكنًا تجميلها أو إخفاؤها، ومن جهةٍ أخرى، الجرأة غير المعتادة لمسؤولة أُممية في تسمية الأشياء بأسمائها.
في هذا السياق، يمكن القول إن ألبانيزي لم تعُد وحدها، حتى لو حاولت حكومات غربية أن تعزلها. فهناك اليوم رأي عام عالمي يتغيّر، وجيل جديد في الغرب نفسه بدأ يشكّك في الرواية الرسمية، ويطرح أسئلة محرجة عن معنى العدالة، وعن حدود التضامن، وعن حقيقة ما يجري في فلسطين. الجامعات، الحركات الطلابية، النقابات، بعض الأصوات الإعلامية المستقلة، كلها تشكّل بيئة تتلقّى خطاب ألبانيزي بتعاطف، وترى في الهجوم عليها تأكيدًا على صحة ما تقول لا نفيًا له.
في النهاية، يمكن القول إن ما جرى مع فرانشيسكا ألبانيزي يتجاوز شخصها ومنصبها، ليصبح جزءًا من معركة أكبر بكثير: معركة الحقيقة في وجه منظومة لا تريد أن تُرى، ومعركة العدالة في عالم يحاول أن يطوّع القانون لخدمة القوة، لا أن يطوّع القوة للخضوع للقانون. قد تنجح الحكومات الغربية في الضغط عليها، وقد تتمكّن من تقليص هامش حركتها داخل الأمم المتحدة، وربما تنجح في إقصائها يومًا ما. لكن ما قيل قد قيل، وما كُشف قد كُشف، وما سُجّل في الوعي العالمي يصعب محوه.