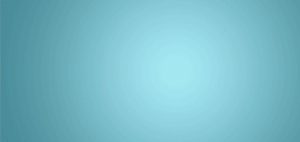خبير تربوي لبناني للوفاق:
ثقافة المقاومة تبني وطناً؛ والاستسلام يُهدِّمه
في عالم مليء بالتحديات والصراعات، تتصارع ثقافتان متناقضتان: ثقافة الاستسلام والهزيمة، وثقافة المقاومة والصمود. الأولى تمثل حالة من العجز والقبول بالواقع، حيث تكتفي المجتمعات بالنظر إلى الأحداث من منظور السلبيات، مما يؤدي إلى تفشي الإحباط وفقدان الأمل في التغيير. تلك الثقافة تُشبه «العين التي لا تقاوم المخرز»، فتُفقد الأفراد قدرتهم على الحلم والعمل من أجل مستقبل أفضل. بالمقابل، تبرز ثقافة المقاومة كفلسفة حياة تعتمد على الفعل والوعي. إنها تدعو إلى مواجهة التحديات بشجاعة، وتعزز من روح التضامن والتعاون بين الأفراد. تتطلب هذه الثقافة أدوات فعالة، مثل التعليم والتوعية، لتعزيز الوعي الذاتي والجماعي، وتفعيل الطاقات الكامنة في المجتمعات. في هذه المقابلة، سنغوص في عمق هذه الثقافات المتصارعة، نستكشف جذورها وأسباب تواجدها، ونبحث في سبل تعزيز ثقافة المقاومة والصمود كوسيلة فعالة للتغيير، سنستعرض أيضًا تجارب ملهمة من مختلف أنحاء العالم تُظهر كيف يمكن للأفراد والمجتمعات أن يتحرروا من قيود الاستسلام، ويعيدوا كتابة قصصهم عبر الإرادة والتصميم، وذلك مع الخبير التربوي والسياسي اللبناني الدكتور ماجد جابر، وفيما يلي نص الحوار:
عبير شمص
ثقافة المقاومة قائمة على مبادئ الكرامة الإنسانية
يشير الدكتور جابر بأن ثقافة المقاومة والصمود تعبّر عن إرادة الشعوب في النضال من أجل حقوقها وكرامتها، وهي تمثل تجسيدًا لقيم الكفاح والثبات أمام التحديات والصعوبات، وهي قائمة على مبادئ الكرامة الإنسانية، ومنبثقة من الإيمان العميق بأن التغيير ممكن، حتى في أحلك الظروف. إنها ليست مجرد رد فعل على الأزمات، بل هي فلسفة حياة تتضمن مجموعة من القيم والممارسات التي تهدف إلى تعزيز الوعي الجماعي، وتحفز الأفراد على اتخاذ خطوات فعالة نحو تعزيز الإيمان بالتغيير عبر تكريس فكرة أن كل فرد قادر على إحداث فرق في مجتمعه، وفي أشد الظروف قسوة، وفي شد الروابط الاجتماعية والتضامن بين الأفراد وتحقيق الأهداف المشتركة للجماعة، فضلًا عن تنمية قدرة الأفراد على التحمل والاستمرار في النضال رغم الصعوبات، مما يُعزز من الإصرار على تحقيق الأهداف. وهي لا تقتصر على فعل المقاومة الجسدي، بل تشمل أيضًا المقاومة الفكرية والنفسية، إذ تُعزز من قدرة الأفراد على التفكير النقدي والتحليل، مما يُسهم في تطوير استراتيجيات فعالة للتغيير.
في المقابل، تجسد ثقافة الاستسلام حالة من الانهزام والانسحاب النفسي والاجتماعي، وتعكس حالة من العجز والقبول بالواقع المرير إذ يستسلم الأفراد للواقع، وينظرون إليه بعين الشك والقلق. هذه الثقافة تتأسس على فكرة العجز، وتؤدي إلى فقدان الأمل في التأثير، وغياب الرغبة في التغيير، والعزلة والانطواء، والتقاعس وغياب المبادرة لحل المشكلات، والنظرة السلبية تجاه الذات والواقع، مما يُعزز من مشاعر الإحباط والركود، ويُدمر الثقة بالنفس، وبالتالي تُعد بمثابة عقبة نفسية واجتماعية تُعيق التقدم وتُدمر الطموح.
إن فهم الاختلاف بين ثقافة المقاومة وثقافة الاستسلام يُعتبر أمرًا حيويًا في مواجهة التحديات المعاصرة. بينما تسعى ثقافة المقاومة إلى بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة الأزمات، ثقافة الاستسلام تُعيق الروابط الإنسانية وتُفشي الإحباط. لذا، فإن تعزيز ثقافة المقاومة والصمود يُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق التغيير الإيجابي وبناء مستقبل يُعزز من كرامة الإنسان ويُعيد له الأمل في الحياة. إن هذا التحول يتطلب جهدًا جماعيًا ووعيًا جماعيًا، من أجل بناء عالم يسوده العدل والحرية.
تعزيز ثقافة المقاومة
يؤكد الدكتور جابر بأنه لتعزيز هذه الثقافة، يجب اتباع استراتيجيات شاملة، تبدأ من التعليم والتوعية عبر إدماج مفاهيم المقاومة وموضوعات حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، وتاريخ النضالات لتعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية في المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، عبر تنظيم ورش عمل للطلاب لتعزيز التفكير النقدي وتمكينهم من تحليل المعلومات والتفكير المستقل، لتعزيز قدرتهم على فهم القضايا الاجتماعية والسياسية المعقدة. كما يمكن الركون إلى الحملات التوعوية الإعلامية عبر استخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر قصص النجاح والنضال، مما يُلهم الأفراد ويُعزز من روح المقاومة، فضلاً عن تعزيز فاعليات الندوات والمؤتمرات المفتوحة لمناقشة القضايا المهمة وتعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية.
ومن أساليب واستراتيجيات تعزيز ثقافة المقاومة والصمود أيضًا، هو أسلوب تعزيز التضامن الاجتماعي عبر بناء شبكات دعم عبر منظمات المجتمع المدني كتأسيس جمعيات ومنظمات لتعزيز الروابط الاجتماعية وتوفير الدعم للأفراد، وإقامة فعاليات مجتمعية لتعزيز الفهم المتبادل والتضامن بين أفراد المجتمع، وتشجيع المشاركة في الأنشطة التطوعية لتقوية روح التعاون والعمل الجماعي، مثل حملات توزيع المساعدات، فضلاً عن تقديم الدعم للمحتاجين من خلال دعم الفئات الضعيفة وتقديم المساعدات الغذائية أو الصحية لها، كما ويلعب التمكين الاقتصادي لأفراد المجتمع دورًا هامًّا في تعزيز ثقافة المقاومة عبر توفير فرص العمل وتقديم التمويل والدعم، والمساعدة التقنية للمشاريع الصغيرة التي تعزز من القدرة الاقتصادية للأفراد، وتوفير التدريب المهني لهم عبر تنظيم برامج تدريبية لتعليم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتعزيز مهارات الابتكار لديهم عبر ورش عمل في ريادة الأعمال، وخلق بيئة تشجع على الابتكار والإبداع مما يُمكّن الأفراد من تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
إضافةً إلى ما سبق، يجب أن لا نغفل عن أهمية الاحتفاء بالتاريخ والنضالات السابقة والشخصيات الهامة ، ونشر قصص النجاح والتجارب الملهمة في المقاومة عبر الإعلام أو في المدارس، وتشجيع النقاش والحوار عبر إنشاء منصات حوارية تُشجع الأفراد على مناقشة القضايا المعقدة وتبادل الآراء، وتدريب الشباب على مهارات التفكير النقدي والتحليل، مما يُساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة، إلى جانب استخدام الفنون ، والمسرح، والموسيقى والشعر، والثقافة بأشكالها المختلفة كأدوات للتعبير عن النضال والأمل والوعي بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والوطنية.
بين الثقافتين تكامل وليس تعارض
تُثير النقاشات حول ثقافة الحياة وثقافة الموت، خاصةً في سياق المقاومة، تساؤلات عميقة حول كيفية فهم هذه الثقافات في المجتمعات التي تواجه تحديات كبيرة أو التي تعاني من النزاعات، وفق الدكتور جابر. ففي سياق ثقافة المقاومة، يُطرح سؤال حول ما إذا كانت هناك مواجهة حقيقية بين هاتين الثقافتين، وما إذا كان هناك تعارض بين مفهوم المقاومة والشهادة من جهة، والحياة والعيش الحر الكريم من جهةٍ أخرى ولكن عبر تحليل أعمق من منظور ثقافة المقاومة، يمكننا أن نرى كيف أن هناك تكاملًا بين ثقافة الحياة وثقافة المقاومة، إذ تُعتبر الشهادة تجسيدًا لقيم الحياة والحرية، إذا ما أردنا تناول ثقافة الحياة، نجد أنها تقوم على الرغبة في تحقيق الرفاهية، الأمن، والاستقرار، وتهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية التي تدعم الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالتعليم، والصحة، وتعزيز قدرة الأفراد على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.
أما ثقافة الموت في سياق المقاومة، أو ما يعرف بالشهادة، فهي تُعد وفق الدكتور جابر بمثابة التضحية من أجل القضايا الإنسانية الكبرى، إذ يُنظر إلى الشهادة كرمز للشجاعة والإيمان، وترتبط بمواجهة الاحتلال وتحدي الظلم، إذ يُعتبر الشهداء رموزًا للبطولة والتضحية والكرامة.أمّا لجهة العلاقة بين الثقافتين، فيراها الدكتور جابر علاقة تكامل وليس تعارض، إذ يُنظر إلى الشهادة في ثقافة المقاومة كجزء من ثقافة الحياة، والشهداء هم أبطال يُضحون من أجل رفعة وطنهم ومجتمعهم ، فهل يعتبر سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله ميتًا، أم شهيدًا حيّا في وجدان وذاكرة الأمّة، تشكل شهادته أساسًا متيناً لبناء مجتمع مقاوم، رافض للظلم والهوان والعيش الكريم على مدى أجيال لاحقة، وبالتالي تُعزز هذه الثقافة من إيمان الأفراد بأهمية النضال من أجل حياة أفضل، كما أن ثقافة المقاومة، رغم تركيزها على الشهادة، تدفع الأفراد إلى العمل من أجل تحقيق حياة كريمة، إذ تبرز أهمية النضال من أجل الحرية والعدالة. ففي المجتمعات التي تعيش تحت الاحتلال، يُعتبر الشهداء رمزًا للكرامة، وتُعزز من قيم التضحية والإيثار وتصبح الشهادة جزءًا من الهوية الوطنية، مما يُعزز من روح الفخر والانتماء".
يلفت الدكتور جابر إلى أمثلة تاريخية على التكامل بين ثقافة الحياة والموت في سياق المقاومة (الشهادة)، على سبيل المثال الثورة الجزائرية لمقاومة الاستعمار الفرنسي، واجه المجاهدون الاستعمار الفرنسي بتضحيات كبيرة. الشهداء الذين سقطوا في المعركة أصبحوا رموزًا للحرية، مما ألهم المجتمع لمواصلة النضال من أجل الاستقلال، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من ثقافة الحياة، وكذلك في انتفاضة الشعب الفلسطيني، يُعتبر الشهداء مثل الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وغيرهم رموزًا للمقاومة. عززت قصصهم من روح النضال لدى الأجيال الجديدة، وهذا ما ظهرت تجلياته في عملية "طوفان الأقصى"، وكذلك تضحيات المقاومين في لبنان، التي منحت شهادتهم تحريًرا لبلدهم عام 2000، مما يُظهر كيف يمكن أن تكون الشهادة دافعًا لتحقيق حياة أفضل.
وهكذا يتضح أن هناك تكاملاً بين ثقافة الحياة وثقافة الموت في سياق ثقافة المقاومة. الشهادة ليست تعارضًا للحياة، بل هي تعبير عن الالتزام بالقيم الإنسانية والعدالة. تعزز ثقافة المقاومة من أهمية النضال من أجل حياة حرة كريمة، مما يجعلها جزءًا من الوجود الإنساني. في النهاية، يُعتبر المجاهدون والشهداء رمزًا للإصرار والتحدي، ويُعزز وجودهم من إيمان الأفراد بأهمية الحياة الكريمة التي تستحق النضال من أجلها.
الخسائر والدمار ليسا سبباً للإنهزام
يعتبر الدكتور جابر إلى أن ثقافة الاستسلام ظاهرة معقدة تتأثر بعوامل متعددة، وغالبًا ما يُستخدم مبررات مثل القوة التدميرية والأذى اللاحق بالناس وأرزاقهم لتبرير هذه الثقافة. في هذا السياق، نجد أنه من المهم تحليل هذه التبريرات وفهم آثارها على المجتمعات.
لا شك أن القوة التدميرية لديها تأثير قوي على المجتمع، إذ عندما تتعرض المجتمعات لتهديدات فعلية مثل الحروب أو الاحتلال، قد يؤدي الشعور بالخوف من العنف إلى تقويض روح المقاومة، ويجعل نسبة من أفراد المجتمع يميلون إلى الاستسلام اعتقادًا منهم أن ذلك سيوفر لهم الأمان. كما أن العواقب النفسية للقوة التدميرية يمكن أن تؤدي إلى حالات من القلق والاكتئاب، مما يضعف جزء من الإرادة الجماعية للنضال ويجعل الأفراد يشعرون بالعجز. وينطوي الأمر نفسه على تأثير الأذى اللاحق بالأرزاق وتدمير الممتلكات والبنية التحتية، مما يُعزز من الإحساس بالعجز، وثقافة الاستسلام لدى شريحة من أفراد المجتمع. إلاّ أن كل ما تقدم لا ينبغي أن يكون مبررًا إذا ما أرادت الشعوب النهوض، ومواجهة الصعوبات، والبقاء راسخة في حياة كريمة وشريفة. فالمقاومة ينبغي أن تكون الرد السريع لكل العوامل الدافعة للاستسلام، خصوصًا أن التاريخ مليء بأمثلة عن حركات مقاومة نجحت في تحقيق التغيير رغم التدمير والأذى بالأرزاق والبشر لبلدانها، ثم عادت شعوبها ونهضت وأصبحت من أرقى المجتمعات، وفي تحقيق العدالة والحرية. فالارتهان للشعور بالاستسلام سيؤدي إلى العديد من العواقب الاجتماعية والسياسية وعدم القدرة على تحقيق التغيير، حيث يتجذر الظلم في المجتمع، فضلًا عن فقدان الهوية الثقافية والوطنية، مما يُضعف الروابط الاجتماعية. كما ان الاستسلام قد يُعزز من استمرار الدورات التاريخية للعنف.
وعليه، في الوقت الذي قد يُعزى الاستسلام إلى الخوف من القوة التدميرية والأذى الذي يلحق بالأفراد، يجب أن نُدرك أن المقاومة هي الخيار الذي يُعيد الأمل ويحقق التغيير لبناء مجتمع قوي وقادر على مواجهة التحديات من أجل بناء
مستقبل أفضل.